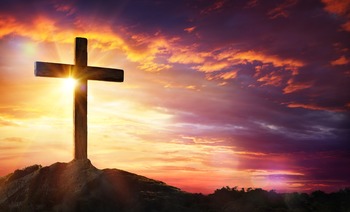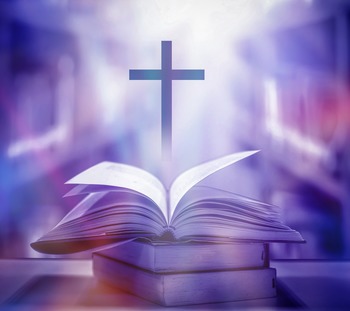الخلاص >
بعض نظريات الكفارة (ج2)
كريستين روماني
10/27/24 - ٥ دقيقة قراءة
نظرية المسيح المنتصر:
تُعتبر تلك النظرية تطورًا لنظرية الفدية. حيث كتب "غوستاف أولين" كتاب بعنوان “Christus victor”، أي: "المسيح المنتصر" والذي نُشر عام 1931، ويشرح فيه كيف أن الفدية لم تُدفع للشيطان، وأنه يجب النظر لهذا المفهوم لا على أساس شكل نظري، بل على أساس كونها رواية درامية تحكي قصة الصراع الإلهي والانتصار على قوي الشر وتحرير البشرية من عبودية الخطيئة. فإن عمل المسيح على الصليب كان إعلانًا عن انتصاره على أعداء البشرية التي تستعبدها (أي: الخطية والموت والشيطان).[1] كما هو مكتوب
"فَإِذْ قَدْ تَشَارَكَ الأَوْلاَدُ فِي اللَّحْمِ وَالدَّمِ اشْتَرَكَ هُوَ أَيْضًا كَذلِكَ فِيهِمَا، لِكَيْ يُبِيدَ بِالْمَوْتِ ذَاكَ الَّذِي لَهُ سُلْطَانُ الْمَوْتِ، أَيْ إِبْلِيسَ، وَيُعْتِقَ أُولئِكَ الَّذِينَ خَوْفًا مِنَ الْمَوْتِ كَانُوا جَمِيعًا كُلَّ حَيَاتِهِمْ تَحْتَ الْعُبُودِيَّةِ."[2]
نقد النظرية:
- تؤكد النظرية على نُصرة المسيح وعلى خلاص واسترداد الإنسان، ويعتبر النقض الأول المُوجه لنظرية الفدية[3] هو ذات النقض الموجه لنظرية المسيح المنتصر التي تعتبر من كلاسيكيات الكنيسة وهي أن النظرية تقع في "الهرطقة الثنائية" التي تصف وجود قوتين دائمتي الصراع (الخير والشر)، (الله وابليس) وهذا يُعطي ابليس أكبر من سلطته.
نظرية الترضية:
صاحب النظرية هو أنسلم من مقاطعة كانتربري في إيطاليا. كان يعيش في سياق اقطاعي وقام بتطبيق صورة اللورد المالك -صاحب الأرض- على الله، والفلاحين على البشرية، حيث كان العبد المُخطئ يُقدم ترضية إلى سيده وإلا يُعاقب. في فكره يقول إن البشر مديونون بالولاء إلى الله اللورد المالك للأرض وما فيها، والخطية هي بمثابة تمرد على هذا الولاء، وتعدي على كرامة الله، ولأن الخطأ في حق الله العظيم كبير والإنسان أفقر وأضعف مِن أن يستطيع تقديم ترضية لله، لذا هو مُستحق للعقاب. والطريقة الوحيدة للتكفير عنه كانت بتجسد المسيح الإنسان الكامل والإله الكامل، الذي عاش في ولاء -طاعة- لله وهو الذي لم يفعل خطية ولا يحتاج أن يُقدم ترضية، قدم نفسه طواعية على الصليب، لذا استحق مكافأة على عمله هذا. ولكون المسيح هو الله المُكتفي -لا يحتاج إلى أي شيء-، لا يحتاج ليُكافأ، قدم لنا نحن تلك المُكافأة لتكون ترضية عما فعلناه أمام الآب، وبهذا استردنا المسيح من عقاب الموت.
نقد النظرية:[4]
- ركزت النظرية على مفهوم العدل الإلهي، ولكنها جعلت الهدف الأساسي للكفارة هو إرضاء كرامة الله لتحقيق هذا العدل دون النظر للبُعد الإنساني للكفارة.
- جعلت "كرامة الله" وكأنها شيء خارج عن الله بل وفوقه يُلزمه بالإرضاء، لا أمرًا مُتأصلًا فيه يتفاعل مع باقي صفاته بشكل مُتكافئ.
- فصلت بين أقانيم الثالوث مُصورة الآب بالغاضب الذي يُريد إرضاء كرامته، عن الابن الرحيم الذي يُقدم نفسه لأجلنا.
- مِن الطبيعي أن يؤثر السياق المجتمعي على رؤيتنا اللاهوتية ولكن من الخطأ أن نُطبق السياق المجتمعي على الكتاب، لا أن نجعل الكتاب يشرح ما يُريد أن يُخبرنا الله به، وهذا ما فعله أنسلم.
نظرية التأثير الأخلاقي:
يُعتبر "بيتر أبيلارد"، و"بول تيليك" مِن رواد تلك النظرية، وهم لاهوتيون عاشوا في عصر التنوير والتحرر في القرن ال 20 حيث التركيز على قيمة الإنسان. وتنفي النظرية فكرة وجود العدل العقابي على الخطية، لذا تري أنه لا داعي للتكفير. وتوضح أن قوة الصليب لا تكمن في تغيير وضعنا أمام الله أو ارضاءه وإنما في تأثيره الأخلاقي على أفعالنا. والفداء هو تلك المحبة العُظمي التي أضرمتها آلام المسيح فينا، فهي محبة لا تُخلصنا مِن أسر الخطية فحسب وإنما هي محبة تحقق لنا حرية أبناء الله الحقيقية، فتصير المحبة هي العاطفة السائدة لا الخوف. وإن موت المسيح على الصليب كان ليُعلن لنا عن محبة الله الفائقة المعرفة، مما يُحركنا بالروح القدس للتفاعل مع تلك المحبة وإعلان توبة حقيقة عن أفعالنا الشريرة، ونحيا حياة أخلاقية مُقدسة على غرار حياة المسيح الأخلاقية، مُتبعين تعاليمه، وناقلين محبته للآخرين.
نقد النظرية:
- قدمت النظرية شرحًا للبُعد الإنساني للكفارة، شارحة تفاعل الثالوث القدوس معنا بعمل المحبة المُبادَر بها مِن الآب والمُقدَّمة مِن الابن، والمُفعَّلة فينا بالروح القدس.
- تغافلت النظرية البُعد الإلهي في الكفارة وتأثير خطيتنا. كما تغافلت عن الكثير مِن المقاطع الكتابية التي تتحدث عن تبعيات الخطية وما تسببت به مِن فساد للبشرية، وعواقبها -الموت-، وأن موت المسيح كان لاسترداد البشرية.[5]
- البعض يُقسم عمل الخلاص إلى ثلاث مراحل: "التبرير" وهو (خلاص من دينونة الخطية)، و "التقديس" وهو (خلاص مِن سلطان الخطية)، و "التمجيد"، وهو (خلاص من جسد الخطية)، وفي رأيهم أن تلك النظرية تغافلت التبرير لأنها لا تؤمن بوجود تبعيات للخطية تستدعي التكفير، وقفزت إلى مرحلة التقديس، مُتغافلة بعض المفاهيم الكتابية.